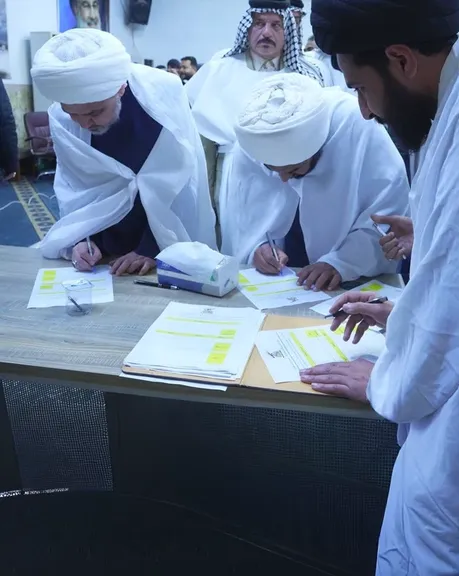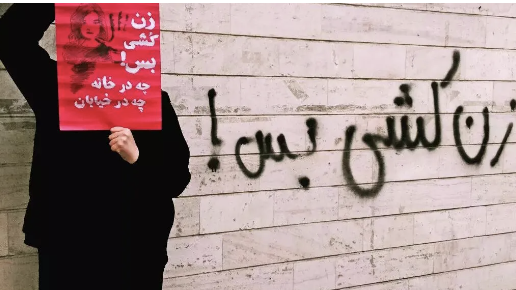وقد طلبت قناة "إيران إنترناشيونال" من متابعيها مشاركة مشاهداتهم حول ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية.
قال أحد المواطنين: "غلاء الدواء كسر ظهور الناس"، وقال آخر: "العديد من الإيرانيين يموتون ببطء بسبب الفقر والمرض".
وأشار إلى أن معظم الأدوية أصبحت باهظة الثمن لدرجة أن الفقراء وذوي الدخل المحدود لا يستطيعون شراءها.
وكانت وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري قد أفادت أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي أن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة تصل إلى 400 في المائة بعد إلغاء دعم العملة التفضيلية وارتفاع الأسعار بشكل عام.
وتحدث كثير من المواطنين عن النقص الحاد في بعض أصناف الأدوية.
وأفاد أحدهم بأن الأدوية المتوفرة في الصيدليات عادةً ما تكون على وشك الانتهاء، حيث لا تتجاوز مدة صلاحيتها المتبقية شهرين إلى ثلاثة.
قال آخر: "تواريخ الصلاحية قريبة جداً، ما يعني أنها كانت مخزنة، ثم طُرحت في السوق قبل انتهائها بقليل".
وذكر مواطن أن الدواء المطلوب إما مفقود تمامًا أو متوفر بصيغة "منتهية أو مقلدة"، خصوصًا في منطقة ناصر خسرو بطهران، حيث "يبيع المدمنون واللصوص والسماسرة الأدوية".
وشكك كثيرون في جودة الأدوية الإيرانية، واصفين إياها بأنها "رديئة جدًا"، "بلا فعالية"، ولا تُحدث أي تحسّن. كما أشار أحدهم إلى هيمنة "الأدوية الصينية الرديئة" على السوق.
قال أحد المواطنين إنه لجأ إلى شراء دواء الغدة الدرقية من تركيا: "دفعت ثمنه بالسعر الحر للدولار، وهو يعادل سعر أربعة أشهر من الدواء الإيراني، لكنه دواء أصلي من إنتاج ألماني، بينما النسخة الإيرانية لا تفعل شيئًا".
وصف هذا المواطن أزمة الدواء والعلاج في إيران بأنها كارثة تعادل "أزمة شح المياه" وغيرها من الأزمات، مضيفًا أن الوضع في إيران يزداد "جحيمًا يومًا بعد يوم".
وأشار آخر إلى أن الغلاء لا يشمل فقط الأدوية بل أيضًا المنتجات الصحية مثل الفوط الصحية، والتي "أصبح العثور عليها صعبًا" وأسعارها ارتفعت كثيرًا.
وفي مثال على ذلك، قال مواطن: "علبة فيتامين الماغنيسيوم وعلبة فيتامين لتقوية الشعر والأظافر والبشرة من إنتاج محلي، وصل سعرهما إلى 570 ألف تومان".
وذكر آخر: "حبوب فوليكوجين لتقوية الشعر والأظافر أصبحت بسعر 700 ألف تومان. نحن مضطرون لاستخدام هذه المكملات لأن الأطعمة في الأسواق غير صحية ولا تحتوي على العناصر المطلوبة".
تأمين صحي عاجز
وأعرب الكثير من المواطنين في رسائلهم عن استيائهم من ضعف التأمين الصحي.
وقال متقاعد: "ذهبت إلى الصيدلية ومعي وصفة طبية، فأبلغوني أن التأمين لا يغطي عدة أدوية.
رغم أنهم يقتطعون من راتبي تأمينًا أساسيًا وتكميليًا. كنت أدفع سابقًا 50 ألف تومان للأدوية البسيطة، والآن دفعت 420 ألف تومان".
وذكر مواطن آخر: "الأدوية المغطاة بالتأمين هي فقط الأرخص، مثل التي تكلف 30 ألف تومان. الأدوية الأغلى ليست مشمولة وتُحسب بسعر السوق الحر".
وكان "سلمان إسحاقي"، المتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان، قد صرح في أبريل (نيسان) الماضي أن 80 بالمائة من تكاليف العلاج يدفعها المريض من جيبه، بينما تغطي شركات التأمين 20 بالمائة فقط، وغالبًا بتأخير.
وصرّح مواطن: "أدوية المرضى الخاصين غير متوفرة في السوق، ويقومون بإرسالها مباشرة إلى السوق السوداء. نحن لا نملك المال لشرائها، وأحباؤنا يموتون أمام أعيننا".
من بين الرسائل أيضًا، أمثلة على التكاليف الباهظة للعلاج: كتب أحدهم: "أجروا لي فحوصات طبية عبر تأمين الضمان الاجتماعي بتكلفة 14.5 مليون تومان. أسأل مسؤولي النظام: هل لديكم أي ضمير؟"
وذكر آخر أن تكلفة "أربعة أنواع من الأدوية الإيرانية وبكميات قليلة لعلاج مرض جلدي" وصلت إلى نحو 3 ملايين تومان.
وفي كثير من الرسائل، عبّر المواطنون عن خوفهم من الإصابة بالمرض.
قال أحدهم: "سعر شريط واحد من كبسولات المضاد الحيوي (سيفيكسيم) التي توصف عادةً لعلاج الالتهابات البكتيرية مثل التهاب الحلق والشعب الهوائية، وصل إلى 140 ألف تومان".
أفاد آخر: "منذ أيام لا أملك الدواء. لم يكن لدي مال، واليوم اقترضت لأشتريه، لكني لم أتمكن من الحصول إلا على نصف الوصفة فقط بسبب ارتفاع الأسعار الجنوني".
وأشار شخص آخر إلى أنه كان يشتري دواءً لابنه الرضيع بـ450 ألف تومان، وأصبح اليوم يكلف 870 ألف تومان.
في فبراير (شباط)، صرّح "هادي أحمدي" عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة في إيران، أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية شكّل صدمة للناس، وواحد من كل ثلاثة زبائن في الصيدليات يتراجع عن الشراء بسبب الأسعار.
كتب أحدهم أن بخاخ التنفس الذي كان يشتريه العام الماضي بسعر 500 ألف تومان ويغطي التأمين 85 بالمائة منه، أصبح اليوم بسعر 3 ملايين تومان، والتأمين لا يساهم في التكاليف.
وقال أحد المواطنين: "من شدة الخوف من التكاليف، نخشى أن نمرض".
وكتب آخر بشكل صريح: "لم نعد قادرين على شراء الأدوية، لم يتبقَ سوى الموت".
وتُظهر التقديرات أن 30 بالمائة من زوار الصيدليات ينسحبون من شراء الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار.