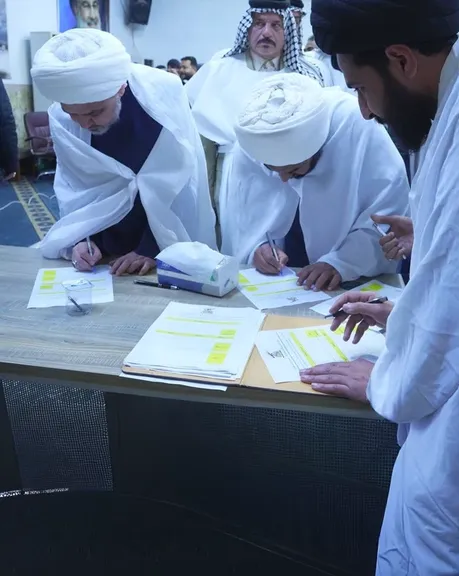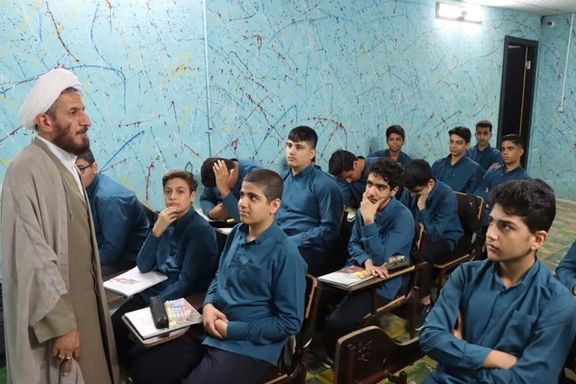وبلغت هذه الحرائق ذروتها يومي 6 و7 أغسطس، حيث سُجّل أكثر من 15 حريقًا في غابات محافظات جهارمحال وبختياري، وكلستان، وأذربيجان الشرقية، وفارس، وسمنان، وكيلان، وكردستان.
وتشير مراجعة بيانات "إيران إنترناشيونال" إلى أن نحو 40 في المائة من الحرائق المبلَّغ عنها في وسائل الإعلام الإيرانية خلال تلك الفترة وقعت فقط في هذين اليومين.
وبحسب مسؤولي منظمة البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، فإن السبب الرئيسي لهذه الحرائق هو الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، الذي زاد من احتمال اندلاع الحرائق في الغابات والمراعي، إضافة إلى جفاف النباتات الذي ساعد على سرعة انتشار النيران.
7 أغسطس: خمس محافظات تكافح حرائق طبيعية
في السابع من أغسطس، اندلعت حرائق في محمية هلن بمحافظة جهارمحال وبختياري، وفي غابات كردكوي بمحافظة كلستان، وفي غابات جلفا بمحافظة أذربيجان الشرقية، وفي مراعي مرتفعات جبل دراك بشيراز، وكذلك في غابة أبر بشاهرود.
وأعلنت سلطات محافظة جهارمحال وبختياري مساء ذلك اليوم أن النيران التي استمرت 24 ساعة في محمية هلن أتت على أكثر من 100 هكتار من غابات البلوط. وتعود تسمية هذه الغابة إلى الممرضة الأميركية "هلن جفريز بختيار"، زوجة طبيب إيراني، التي كانت تقدّم العلاج لسكان المنطقة.
أما في محافظة كلستان، فقد شهدت ثلاثة مواقع مختلفة من غابات كردكوي حرائق في 5 أغسطس، وتمت السيطرة عليها خلال 24 ساعة. وأرجعت السلطات المحلية السبب إلى "إهمال بشري، وظروف جوية سيئة، ورياح قوية".
وفي غابات قره داغ بمدينة جلفا، تمّت السيطرة على الحريق بعد عدة ساعات، وقالت إدارة الموارد الطبيعية في أذربيجان الشرقية إن الحرارة الشديدة هي السبب، محذّرة من احتمالية اندلاع حرائق مماثلة قريبًا.
كما اندلع حريق في غابة أبر بشاهرود، وتمت السيطرة عليه بجهود فرق الهلال الأحمر والموارد الطبيعية وحماية البيئة والسكان المحليين.
حرائق متكررة في جبل دراك قرب شيراز وسط شبهات بوجود منشآت عسكرية
في يومي 5 و6 أغسطس، اندلعت حرائق في مرتفعات دراك قرب مدينة شيراز، وتمت السيطرة عليها بعد يومين.
أول حريق في هذا العام بالمنطقة سُجّل يوم 9 مايو، وأُرجع سببه إلى الحرارة وجفاف النباتات.
وبعد يومين فقط، في 11 مايو، اندلع حريق آخر في مناطق وعرة، تلاه حريق ثالث في 24 يوليو.
تكرار هذه الحوادث أثار تكهنات حول وجود منشآت عسكرية سرية في الجبال المحيطة بشيراز.
ومع ذلك، أكد مدير إدارة الأزمات بمحافظة فارس يوم 5 أغسطس أن الحريق كان في الجهة الجنوبية لجبل دراك، وأوضح رئيس هيئة الإطفاء في شيراز لاحقًا أن الحريق لم يكن قريبًا من أي موقع عسكري، بل سببه الجفاف وكثافة الغطاء النباتي، ما استدعى استخدام مروحيات للإطفاء.
خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والمراعي
في يوم 5 أغسطس فقط، أتت النيران على:
• 20 هكتارًا من الأراضي الزراعية في مدينة خدا آفرين (أذربيجان الشرقية).
• 15 هكتارًا من مراعي محمية عبد الرزاق (كردستان).
• أجزاء من غابات أرَمند وبساتين أردل (جهارمحال وبختياري).
• 23 هكتارًا من مراعي "بوئين مياندشت" (على الحدود بين أصفهان ولرستان).
• 20 هكتارًا من مراعي "سياكمر" بمنطقة "ميقان" (شاهرود).
سوء إدارة الموارد المائية وزيادة الجفاف
يحذر المسؤولون الإيرانيون منذ أشهر من أن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يزيد من خطر الحرائق، لكن التغير المناخي ليس السبب الوحيد. فالجفاف الطويل وانخفاض رطوبة التربة جعلا الغطاء النباتي أشبه بوقود ينتظر شرارة.
وقد حذّر خبراء البيئة منذ سنوات من آثار الضخ المفرط للمياه الجوفية، الذي أدى إلى فقدان الرطوبة في الأراضي. ووفق تقرير نشرته صحيفة "اعتماد" في 2 أغسطس 2025، نقلًا عن الخبير البيئي محمد درويش، فإن مخزون المياه الجوفية في إيران وصل إلى مرحلة لا يمكن تعويضها حتى إذا توقف الضخ نهائيًا، وقد يستغرق التعافي أكثر من 70 ألف عام.
غياب الإجراءات الوقائية وتحميل المواطنين المسؤولية
كشف علي عباس نجاد، قائد شرطة حماية الغابات والمراعي، في منتصف يوليو (تموز) أن عدد حرائق الغابات في يونيو (حزيران) 2025 ارتفع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأن 95 في المائة من هذه الحرائق كان وراءها عامل بشري.
وأشار إلى أن برودة الطقس في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) قللت من زيارات المواطنين للمناطق الطبيعية، ما ساهم في انخفاض الحرائق حينها. لكن إحصاءات درجات الحرارة في تلك الفترة تشير إلى أنها كانت معتدلة في عدة محافظات.
ويرى منتقدون أن المسؤولين يتجنبون الحديث عن فشل السياسات البيئية والإجراءات الوقائية، وبدلًا من ذلك يلقون اللوم على المواطنين أو الظروف الطبيعية، في محاولة للتغطية على سوء الإدارة ومنع أي نقد فعّال.